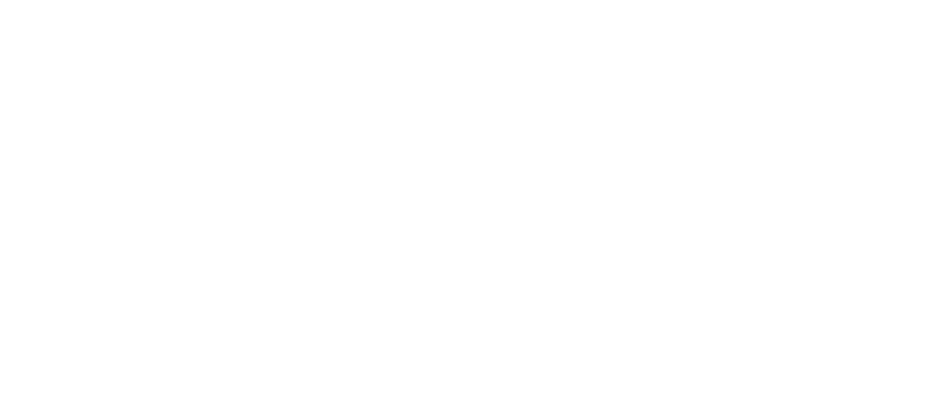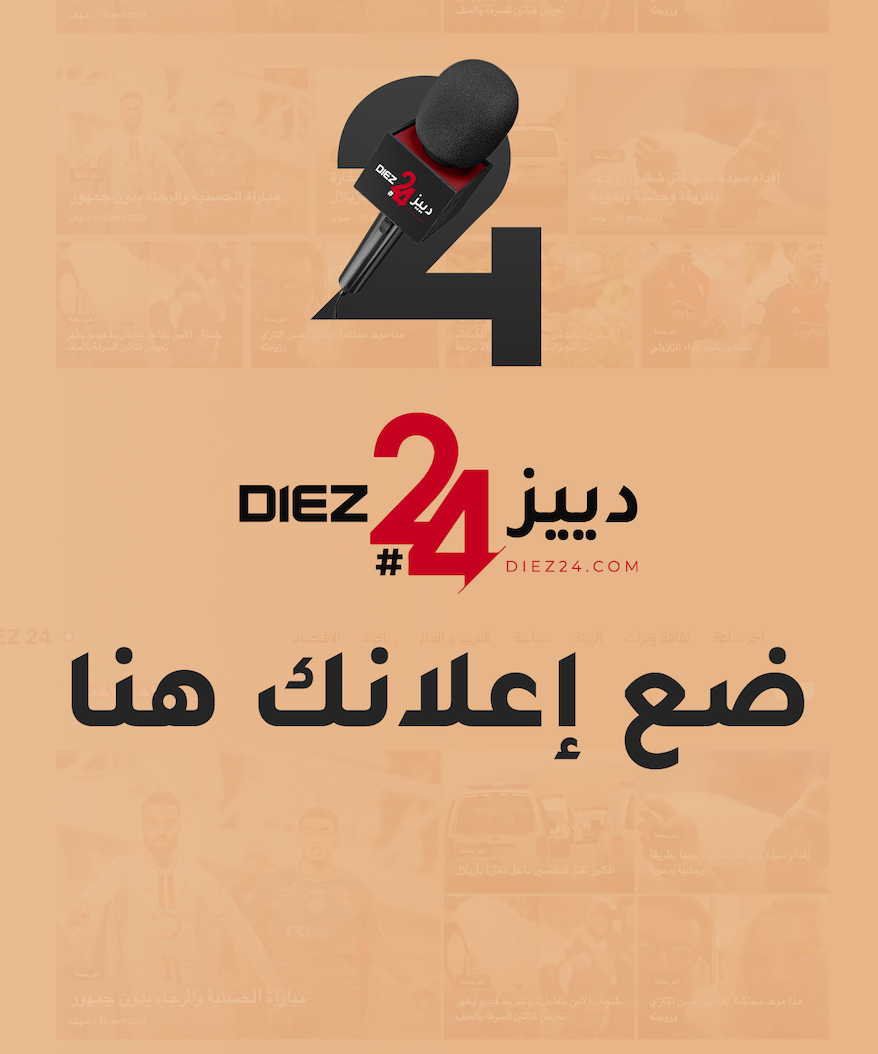من مكة إلى القدس المحتلة، ومن الصين إلى الشام، ومن أوزبكستان إلى الهند، ومن “الفردوس المفقود” إلى تركيا ودول أخرى، تدون الأكاديمية نجاة المريني ملاحظات، وتقدم مقارنات، وفوائد أسفار عديدة. وقد صدرَ نصّها عن منشورات مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
بعنوان “ارتسامات وانطباعات عن مسار رحلات” تقدّم المريني مُدوَّنَ مشاهداتها، ومعيشها، وملاحظاتِها للاعتبار، مع حضورِ مقارنات عمّا يقرب المغرب من الدول العربية، وما يذكّر بالعربيّ والمسلم في غيرها من الدول، وترصيع للنّثر بعيون الشّعر العربي وفق الموضوعات والمرادات.
وفي تقديم الكتاب ذكر بوشعيب بن إدريس فقار، محافظ مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن في هذه المذكرات “يتزاوج العشق العميق بمعرفة ربوع كثيرة ومختلفة من مناطق العالم، مع الشغف الكبير بمعرفة الله تبارك وتعالى من خلال ما برأ وما خلق، ويمتزج الوصف العلمي لطبائع مجتمعات متعددة مع معتقداته وأساطيره، وينتقل المُتخيَّل في الضمائر إلى واقع العوالم بكل متناقضاتها. كل ذلك رسمته ريشة بديعة مبدعة، لا تمتلكها إلا أديبة مفكرة اسمها الدكتورة نجاة المريني”.

في سوريا سنة 2008 وجدت المريني بمحيط مقام محيي الدين بن عربي الحاتمي صاحب “الفتوحات المكية” أسواقَا شعبية ذكرتها بـ”أسواق مولاي إدريس الأكبر بمدينة زرهون” حيث “يتهافت الناس على اقتناء الشموع والحلويات وغيرها مما يعتبر زادا ذا بركة”. كما حضرتها في دمشق صورة نزار قباني فتى دمشقيّا يقول: “وددت لو زرعوني فيك أي دمشق مئذنة أو علقوني على الأبواب قنديلا”.
كما تحضر في المذكرات مناجاة المريني قلمَها: “فضاءات كثيرة تذكرك بما للعقل العربي من قدرات على تحقيق المستحيل وعلى إثبات الذات بخلق وعلم، فكيف سنستعيد نحن العرب ما فقدناه بعد فترة خمول من بريق حضارتنا ونضيف إليه جديد العصور وتقنيات العلوم؟ إنه السؤال المحير الذي يحيل إلى وجوب توحيد الجهود، والعمل الرصين، بإباء وعزة نفس، لاستعادة ما اندثرت حباته بفعل الانشقاق، والنفاق، والمزايد على الرئاسة والسلطان”.
ووجدت الكاتبة بلدة المعرّة “مفتخرة بحكيم شعرائها وفيلسوف زمانه أبي العلاء المعري، الشاعر الخالد بلزومياته وسقط زنده”، مضيفة “وكم حبّب إليّ هذا الشعر أستاذي الدمشقي البهيّ الدكتور أمجد الطرابلسي، في دروسه الجامعية بكلية آداب الرباط، وهو يتسلل إلى عقولنا بهدوئه واتزانه، وعلمه وعطائه”.
وفي الصين أمّنت المتخصّصة في الأدب المغربي على ما أملاه ابن بلدِها ابن بطوطة قائلة: “بلاد الصين على الرغم من بعدها والمسافات الكبيرة التي قطعناها تستحق زيارتها والوقوف عند معالمها، وحضارتها العريقة، والإعجاب بانتظام سكانها في أعمالهم وفي الحفاظ على شموخ وطنهم، ولعل إعجاب ابن بطوطة ببلاد الصين له ما يبرزه في عصره، فكيف به إذا زارها اليوم ووقف معجبا بما حققته عبر العصور من تقدم وازدهار”.
وأردفت أن “المثير للانتباه هو ما تحفل به بيكن من مطاعم إسلامية، تقدم الأكلات الحلال مع الأنغام العربية، التي تعود بك إلى الجو العربي الإسلامي في بلاد يصعب التخاطب مع سكانها إلا عن طريق المرشدة التي تتقن اللغة الفرنسية للتفاهم مع الوفد المغربي الزائر”.
أما خلال الرحلة المرينية إلى المكتبات الإستنبولية التركية، فكان المدوَّن: “لعل ما يبعث على الاعتزاز بهذه المراكز الثقافية أنها تضم عددا كبيرا من المؤلفات المغربية في تخصصات مختلفة، وقد أبدى قيّم مكتبة مركز البحوث الإسلامية اهتماما بما يحبره الكتاب المغاربة في الأدب والفكر الإسلامي، منوها بجهودهم في كل وقت”، قبل أن تردف “أعتقد أن تشريع تدريس اللغة العربية اليوم بالمدارس التركية يؤكد ما للغة العربية من إشعاع وحضور كلغة عالمية”.
وفي حديثها عن “الموسوعة الإسلامية” التركية واستيفائها 40 مجلّدا، استحضرت المريني أهم الموسوعات المغربية، وهي من طاقم تحريرها “معلمة المغرب”، وذكرت أنها ساهمت في الأولى أيضا بطلب من الموسوعة التي ترجمَت ترجماتِها إلى اللغة التركية للتعريف بشخصيات علمية مغربية، هي: عبد العزيز الفشتالي، وعبد الله كنون، وإبراهيم الرياحي، وعبد العزيز الثعالبي.
وبأوزبكستان، الدولة المسلمة في قلب آسيا الوسطى، المستقلّة عن الاتحاد السوفياتي سابقا، أحسّت المريني بطعم خاص، مع رحلة “تعيد الزائر إلى استحضار قرون مضت، وإلى قراءة ثانية للتاريخ الإسلامي، وإلى اكتشاف الروح الإسلامية الحقّ عند السكان على الرغم من عجمتهم، وإلى اعتزازهم بدولتهم ومؤسسها وصانِع مجدها”.
وإضافة إلى تجربة استيعاب موضوعِ خطبتي الجمعة انطلاقا من الاستشهادات القرآنية والحديثية فقط، والأسواق الشعبية المُغرية باقتناء التذكارات، وضريح مؤسس الطريقة النقشبندية، سجّلت الكاتبة أن “الزائر لأي جامع سيلاحظ براعة الفنان الأوزباكستاني في النقش والزخرفة، حيث تم نقش الآيات القرآنية على أبواب الجامع وقبابه بخطوط بديعة باللغة العربية لتحكي براعة مدهشة في فن الزخرفة والنقش بألوان متناسقة زاهية”.
كثيرٌ من رحلات الكتاب، كانت عمرات أو حجاّ إلى مكة والمدينة، استمرارا في الرحلات الحجازية المغربية، مع صدح بانتقاد اختلالاتِ القادمين والمنظّمين: “إنها مظاهر التخلف ومظاهر الجهل بأخلاق الإسلام”، مع توثيق أن الطواف بالكعبة “يبعث في المرء راحة نفسية وجسدية على الرغم من المشقة والازدحام”.
وفي القدس كتبت المريني مثبتة استنانَها بتخليل المغاربة؛ “أمل كل المسلمين في بقاع الأرض أداء فريضة الحج والصلاة بالمسجد الأقصى، وبالقدس الشريف، بلاد الأنبياء والرسل، كان المغاربة كلما عزموا على أداء فريضة الحج إلا وبرمجوا زيارة القدس للصلاة بالمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة، وبذلك يحقق الحاج حلم الصلاة في المساجد الثلاثة التي تُشدّ إليها الرحال، والحرم الكي والمدني والقدسي”.
ومنذ بداية الرحلة كتبت المريني “كان الشعور وأنا على مشارف القدس أستعد لتنسُّم هوائها والارتواء من قدسيتها ممّا يبعث على الرضا وعلى الاطمئنان، وإن كان مصحوبا بحسرات على الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، وعلى جبروت الأعداء السالبين لأرض أصحابها”.
وبخصوص الطريق إلى المسجد الأقصى تحّدثت عن “أزقّة عربية ضيقة، وكأننا في أزقة سلا أو فاس”، وعن قراءات أشعار البوصيري، ومن بينها “البردة” بالمسجد الأقصى. كما تحدثت عن دعوات الإمام بعد انتهاء صلاة الصبح، التي “تبعث في النفس طمأنينة على الرغم من كل المثبطات وكل الأوضاع المؤلمة التي يعيشها الشعب المقدسي والشعب الفلسطيني، فيشعر المرء براحة نفسية ممزوجة بأمل تحرير الأرض، وتحرير المدينة المقدسة، من براثن الشرذمة المستعمرة لأرض الأنبياء ومسرى الرسول عليه السلام”.
ومن بين ما وثّقته المذكّرات المرينيّة “درس ديني لأحد علماء بيت المقدس حول البر بالوالدين، وما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تلحُّ على ذلك، داعيا إلى التمسك بالأخلاق الإسلامية في سموها وطهرها، لافتا الانتباه إلى التردي الذي تعرفه البلاد الإسلامية، وعن واقعها السياسي ومشاكل سكانها وغيرها مما يعرفه الجميع مؤملا أن تنتفض الحكومات لتغيير الواقع الأليم بالعمل الجاد وليس بفقاقيع الكلام”. وعلّقت على ذلك بالقول: “درس ديني متميز، بلغة صافية، وفصاحة تبعث على الارتياح، ويؤكّد ما للمقدسيين من شجاعة في النصح والتوجيه، في عصر نضبت فيه كلمة الحق على الأفواه تقية وخوفا”.
أما “الفردوس المفقود” فكان ختام المذكرات بهِ “كانت رحلة منعشة للذاكرة لاستحضار مجد بلاد الأندلس في كل وقت، والتأسي على كل الظروف التي أتت على حضارة زاهية، وعلى مركز إشعاع علمي لم يتكرر إلى اليوم، وهكذا فقد استفرد الإسبان اليوم بمعالم ومآثر الأندلس الساحرة، في تحريك النشاط السياحي ببلادهم، فضمنوا سياحة متفردة نشيطة، صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا”.